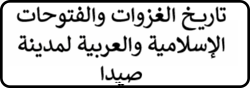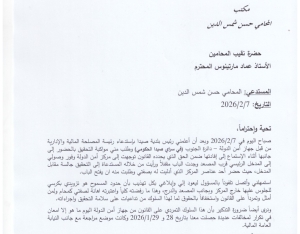الشرق الأوسط» تنشر حلقات من كتاب ديفيد هيل «الدبلوماسية الأميركية تجاه لبنان»

التصنيف: أقلام
2024-03-03 09:54 م 894
كل مقال يعبّر عن رأي كاتبه، ولا يمثّل بأي شكل من الأشكال سياسة الموقع.
تبدأ «الشرق الأوسط» نشر حلقات من كتاب «الدبلوماسية الأميركية تجاه لبنان: ست محطّات وأمثولاتها» لوكيل وزارة الخارجية الأميركية السابق للشؤون السياسية ديفيد هيل. يقدّم هيل في كتابه تقييماً لسياسة بلاده تجاه لبنان، متوقفاً عند إخفاقاتها ونجاحاتها، علماً بأن تجربته اللبنانية بدأت منذ أن كان في أسفل السلك الدبلوماسي، قبل أن يتولى منصب السفير لدى لبنان، ولاحقاً منصب وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية.
وفي ما يأتي نص الحلقة الأولى:
لقد كان لبنان جزءاً كبيراً من حياتي. بدأ الأمر مع جدَّي اللذين كانا يحبّان السفر حول العالم، ووجدا لبنان وجهة تستحق السفر قُبيل ولادتي سنة 1961. أرسلت جدتي إلى بيتنا بطاقةً بريدية تصف بيروت بأنها «مدينة جميلة ورومانسية. الجميع طيّبون للغاية، أصدقاء الأصدقاء يرفّهون عنا برحلات. ليلة أمس ذهبنا إلى كازينو ذائع الصّيت حيث شاهدنا عرضاً في الطابق الفرنسي الشهير، تخيّلوا أننا أوينا إلى الفراش في السّاعة الثانية بعد منتصف اللّيل!».
كانت للبنان مكانته الخاصة أثناء أحاديث مائدة العشاء، خاصةً بعد أن دمّرت الحرب الأهلية المأسَاوية بعضاً من ذاك الجمال والرومانسية، اللذين اجتذبا جدّي وحياة العديد من أصدقائهما الجدد هناك. أحد أساتذتي الجامعيين، أرمين ماير، شغل منصب سفير الولايات المتّحدة لدى لبنان في تلك الفترة الذهبية نفسها من أوائل ستينات القرن العشرين. كان معلِّماً بالنسبة إليّ في مطلع الثمانينات، أيّ في الفترة التي دخل فيها الاهتمام الأميركي بلبنان دوامة التوقّعات التي أعقبها الاشمئزاز. لقد مرّر لي علّة الشغف بالشرق الأوسط ووعياً صحياً بمخاطر لبنان وتعقيداته.
أول مرّة وضعت قدمي في لبنان كانت في سبتمبر (أيلول) 1988، بعمر 27 عاماً. وكان ديك (ريتشارد) مورفي، مساعد وزير الخارجية، في مهمّة إنقاذية ترمي إلى تسهيل عملية اختيار رئيس لبناني مقبول من الرئيس السوري حافظ الأسد والقيادات اللبنانية. وكان مفتاح الحلّ هو قبول المسيحيين الموارنة بمَن سيقع عليه الاختيار، من بينهم بموجب الميثاق الوطني غير المكتوب. كانت تلك الرّحلة الفصل الأخير من مسرحيةٍ دبلوماسية أميركية استمرّت لمدّة عام، تسابق الموعد النهائي لانتهاء ولاية الرّئيس آنذاك أمين الجميّل.
أعطى الاحتلال السوري لجزءٍ كبير من لبنان الأسد معظم الأوراق، ولكن مورفي أراد منه أسماء مرشّحَينِ أو ثلاثة وسطيين للرّئاسة، لإعطاء اللبنانيين المسيحيين الموارنة خياراً يحفظ لهم ماء الوجه من قائمة الأسماء التي اختارها الأسد. لقد كنتُ مساعد مورفي لشؤون الموظّفين، أيّ أنّني كنت في أسفل درجات الهرم الوظيفي في وزارة الخارجية. كانت تلك رحلتي الأولى معه، ووظيفتي الإشراف على التفاصيل اللوجستية.
بعدما تركه ينتظر لمدّة أسبوع في دمشق، استدعى الأسد مورفي في إحدى الأمسيات، وأعطاه اسم مرشّح واحد «مخايل الضّاهر». كان الضّاهر محامياً وعضواً في البرلمان من منطقةٍ شمالية متاخمة لسوريا وخاضعة لنفوذها، ومتحالفاً مع عائلة فرنجية النافذة. عاد مورفي من القصر الرئاسي، وجمع فريقه في حديقة بيت السفير الأخير تجنّباً للتنصّت. ودار نقاشٌ ساخن. لم يكن ما ينقله مورفي خياراً، بل كان إنذاراً نهائياً للقادة الموارنة، وكنا نعلم أنهم سيرفضونه. وبالنظر إلى اقتراب الموعد النّهائي لخروج الجميّل من القصر، قرّر مورفي أن لا خيار أمامه سوى التوجّه إلى بيروت في اليوم التّالي، والاستفادة القصوى مما قدّمه له الأسد. ذهبنا جميعاً إلى النوم. ولم يخطر ببالي أن على أحدٍ ما أن يرتّب أمر انتقالنا إلى بيروت، وأن هذا «الأحد» هو أنا.
أثناء الليل، تسرّب خبر مجيئنا إلى بيروت بطريقة ما. تولّى القائم بأعمال سفارتنا هناك، دان سيمبسون، الإعداد للاجتماعات اللازمة وتنسيق ترتيبات الطيران المعقّدة (طائرة للقوّات الجوية الأميركية أخذتنا إلى قبرص، ومن هناك ذهاباً وإياباً إلى بيروت بمروحيات للجيش الأميركي). بقيتُ غافلاً عن إخفاقاتي إلى أن بلغنا مهبط المروحيات في السفارة. انتحى بي سيمبسون جانباً؛ وأنّبني كما أستحق. وأنا واثق بأن السّبب الوحيد لعدم تخفيض رتبتي هو أنه لا رتبة أدنى من مساعد
أما بالنسبة إلى الصورة الكبرى، فقد اختصرت الرسالة التي حملها مورفي إلى اللبنانيين بأنها «الضاهر أو الفوضى». لم يكن مورفي يميل إلى مثل هذه العبارات الفاقعة، لكنها كانت جوهر رسالته. كما توقّعنا. رفض الموارنة إملاءات الأسد، ولكن من دون أن يكون لديهم بديل. غادر الجميّل منصبه في الوقت المحدّد، وسلّم المفاتيح إلى قائد الجيش اللبناني ميشال عون. (...) وسقط البلد بالفعل في حالةٍ من الفوضى؛ مزّقت أزمة دستورية الحكومة، وولّدت مضماراً جديداً للقتال، ليس بين المسلمين والمسيحيين فحسب، بل بين المسيحيين أنفسهم. وفي نهاية المطاف، جثا اللبنانيون على ركبهم واكتملت السيطرة السورية.
بعد ثلاث سنوات عيّنتُ في لبنان، بعدما تطوّعتُ لشغل منصب المسؤول السياسي والاقتصادي والإعلامي الوحيد في السفارة. وبمجرّد وصولي، اغتال الإسرائيليون الأمين العام لـ«حزب الله» عبّاس الموسوي. وأُجلي السفير رايان كروكر ضد إرادته للحفاظ على سلامته. التقينا على عشاءٍ من جبنة الحلّوم والنبيذ الأحمر في فندق نجمتَين في لارنكا - قبرص؛ كان قد نزل لتوّه من طائرة هليكوبتر للجيش، خارجة من عاصفة مطرية خطيرة، ويُفترض أن أستقلّها في اللّيلة التالية. عاد بعد ذلك إلى بيروت، لكنّنا قضينا معاً الأشهر الأربعة التّالية مسجونين في السفارة. في بلدٍ طبيعي قبل الإنترنت والهواتف المحمولة، كان من شأن هذا الوضع أن يعزل الدبلوماسيين الأميركيين ويشلّهم. ما حصل كان عكس ذلك، فبمساعدة مستشارنا السياسي اللبناني المتميّز غابي عكر، الذي خلفه فادي حافظ بعد التقاعد، شقّت شخصيات لبنانية متنوّعة طريقها إلى سفارتنا الواقعة على قمّة تلّ. لقد أرادوا الاجتماع بكروكر، لكن أُحيل بعضهم إليّ.
لقد اعتادت كلّ فئة لبنانية أن تَستَغِل، وتُستَغَل من قبل القوى الخارجية، حرصت على أن تكون لها علاقاتها الخاصة مع سفارات القوى العظمى. في تلك المرحلة، بعد الحرب الأهلية مباشرةً، كان الاتّصال بوزارة الخارجية اللبنانية مجرّد علاقة من علاقات؛ لا تحصى ولا تُعَدّ حافظت عليها سفارتنا مع صنّاع القرار اللبنانيين. كانت تلك العلاقة أبعد ما يكون عن كونها الأكثر أهمية بين علاقاتنا، إنّها حقيقة محزنة بالنسبة إلى الدبلوماسيين اللبنانيين الموهوبين، الذين كانوا يمثّلون دولة عاجزة، وليس بالضرورة ممّن كانوا يمثّلون قادة الفصائل النّافذة
في البداية، أربكني هذا الوضع. ومع تخفيف الإجراءات الأمنية، بقي سفيرنا سجيناً، لكن سُمح لي بالذهاب لمقابلة اللاعبين اللبنانيين. يبدو أن الاهتمام قليل في لبنان بما يحدث بعيداً من مأدبة متقنة، لذلك غالباً ما تلازمت الاجتماعات مع غداء أو عشاء لذيذ وطويل. لقد وجدت مُحاوريّ اللبنانيين فضوليين للغاية بشأن الموقف الأميركي من الأحداث اللبنانية الجارية، وقد ركّزوا على أول انتخابات برلمانية منذ سنة 1972.
كان المسيحيون يتساءلون ما إذا كان من الأفضل مقاطعة الانتخابات، أو المشاركة فيها اعتراضاً على الهيمنة السورية على البلد وعلى العملية الانتخابية. تطوّرت أسئلة مضيفيَّ على مدار الوجبات إلى مطالب لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتّحدة تريد منهم المشاركة أم المقاطعة، حتّى يعرفوا أين يقفون منّا عند اتّخاذهم القرار.
لم تكن مهامي السابقة في المملكة العربية السعودية والبحرين وتونس والأردن قد أعدّتني لهذه اللقاءات. لم يسألني أحدٌ في تلك البلدان قطّ عما يجب عليهم فعله؛ إذ بدوا فيها مهتمّين فقط بإخباري بما ينبغي للولايات المتّحدة أن تفعله عادةً بشأن الإسرائيليين والفلسطينيين. لقد أذهلتني مطالبة كبار السياسيين اللبنانيين للحصول على آراء ونصائح حول شؤون لبنان الداخلية، فقرّرت عدم الإجابة. ولم يؤدِّ هذا إلّا إلى إرباك اللبنانيين، الذين أرادوا أن يلمسوا النيّات الأميركية بشكل واضح. فالإجابات الغامضة لمستشار سياسي غير ناضج يمكن أن تُعقّد الأمور، أو حتى تعكس وجود خطّة أميركية ملتوية إن كانت غير واضحة.
بعد جلسات عدّة على هذا المنوال، لا بدّ أن الأمر وصل إلى كروكر، الذي أوضح لي أنه سواء أحببنا أم لم نحب ذلك، لا يمكننا أن نُخرج أنفسنا من شؤون لبنان الداخلية. ومن الأفضل أن أدخل على الخط؛ وأبدأ بإسداء النصائح للموارنة بالمشاركة في الانتخابات. (...) لقد قمتُ بذلك بتفانٍ، لكن معظم الموارنة قاطعوا الانتخابات رغم ذلك. وكان ذلك من حقهم، لكنه أضعف موقفهم لأنّه أفسح في المجال أمام إنتاج برلمان أكثر فائدة للمحتلّين السوريين. لقد تعلّمت درساً ثانياً، أبعد من الخدمات اللوجستية: «إن للتدخل الأميركي في لبنان، أو للإحجام عنه، عواقب؛ كلاهما يتطلّب دراسة متأنية».
واصلت بعد جولتي الأولى في بيروت مواجهة القضايا اللبنانية، سواء بصفتي مستشاراً سياسياً أميركياً في مجلس الأمن من خلال مناقشة مسألة قانا عام 1996، أو ضمن طاقم الوزيرة (مادلين) أولبرايت أثناء قيامها برفع الحظر المفروض على سفر المواطنين الأميركيين إلى لبنان. وبصفتي رقم اثنين في السفارة، شاهدت الانسحابَ الإسرائيلي الأحادي الجانب عام 2000، وفَشلَنا في بذل جهد لإعداد الدولة اللبنانية، أو الجيش اللبناني، لتلك اللحظة. وبصفتي سفيراً بعد اثنتي عشرة سنة، أسهمت في الجهود المبذولة لحماية لبنان من التطرّف التكفيري من خلال تأمين دعم قوي للجيش اللبناني.
كانت زيارتي الأخيرة إلى بيروت خلال إدارة ترمب، بصفتي مساعداً لوزير الخارجية للشؤون السياسية، في 13 أغسطس (آب) 2020، بعد انفجار المرفأ في الرّابع منه. كنت مهيأ للدمار المادي، بعد أن رأيت المدينة في أسوأ أحوالها إثر نهاية الحرب الأهلية قبل ثلاثين عاماً. ما لم أكن متأكّداً منه هو ردّ فعل الناس؛ خاصة اللبنانيين العاديين الذين تعرّضوا للخيانة مرّة جديدة بسبب فساد قادتهم وإهمالهم. وجاء الانفجار في سياق أسوأ انهيار اقتصادي ومالي عرفته دولة في العصر الحديث، مع تفشٍّ لوباء «كوفيد-19»، واستمرارٍ لتدفّق اللاجئين من سوريا، زادا الوضع الإنساني بؤساً.
كانت رحلة ليلية طويلة من واشنطن في طائرةٍ صغيرة محمّلة بإمدادات إغاثية لمواجهة «كوفيد – 19»، تخلّلتها محطّتان للتزود بالوقود. عند الهبوط، توجّهت أنا والفريق مباشرةً إلى موقعٍ بالقرب من المرفأ أقام فيه المتطوّعون مخيماً للإغاثة. لم يجرؤ أيّ سياسي أو مسؤول حكومي لبناني على الظهور هناك في الأسبوع الذي تلا الانفجار، ولم أكن متأكّداً مّما عليّ توقّعه. إن رؤية بعض أبناء وبنات أصدقاء قدامى في هذا التجمّع، إضافة إلى بضعة أشخاص أعرفهم من المنظّمات غير الحكومية، جعلتني فخوراً بهم. وكان الاستماع إلى شروحات عن العمل الجاري – من دون أدنى مساعدة من الحكومة اللبنانية – ملهماً، والكرم الذي عايناه استثنائياً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المبادرات اللبنانية المكرَّسة لمساعدة المشرّدين الجدد على استعادة حياتهم من خلال تقديم الغذاء والماء والدواء لهم، وأعمال الإصلاح السريع لمنازلهم، ووضع استراتيجيات إغاثة طويلة الأجل.
كان هناك عدد من أفضل المهندسين وعباقرة الكمبيوتر والمنظّمين والعاملين المحترفين في مجال الصّحة الشباب في لبنان، الذين تركوا وظائفهم اليومية لمساعدة جيرانهم. أعرب الحشد عن تقديره للاهتمام الأميركي بعملهم! لكن كان هناك نوع من احتجاج صغير: في طريق العودة إلى سيارتي كانت هناك مجموعة تحمل لافتات وتهتف (No Bailout). كانوا يخشون أن أكون هناك لأتعّهد بإنقاذ التركيبة الحكومية اللبنانية المفلسة بكلّ معنى الكلمة، التي كان يُنظَر إليها على أنها متواطئة بشدّة في التفجير الحاصل. طمأنتهم برفع إبهامي، وردّدتُ في كلّ فرصة متاحة خلال الأيام التالية عبارة: «لا إنقاذ» من دون إصلاحات ملموسة. وحتى ذلك الحين، فإن مساعدتنا الاقتصادية، ستذهب، كما في العقود الماضية، مباشرةً إلى الشعب اللبناني.
كان هذا التجمّع بمثابة ترياق لسنوات من التحليل العبثي الساخر حول الطبيعة الوحشية للنظام الطائفي في لبنان. كان من الصعب ألّا نشعر بالتأثّر، سواء بسبب الدمار المحيط بنا، أو من جراء العزم والمستوى العالي من الإنسانية والكرامة. وسرعان ما تبدّد هذا المزاج الملهم لدى الاجتماع بالمسؤولين الحكوميين والنخبة السياسية في البلد. إنهم جميعاً أصدقاء محترمون، لكن غياب القيادة، والرغبة في التنصّل من اللّوم، وعدم القدرة على تنحية خلافاتهم جانباً حتى لفترةٍ وجيزة لمعالجة الأزمة، كان مخيباً للآمال، وإن كان متوقّعاً، بخلاف ما رأيته في محطّتي الأولى.
وبينما كنت أتجوّل في المرفأ في اليوم التالي، أذهلتني أيضاً مفارقة. خلال الحرب الأهلية، دمّرت بيروت بشكلٍ منتظم عبر الاستخدام المتعمَّد للعنف. في هذه الحالة، كان الانفجار - وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجّلة - حادثاً واضحاً ناجماً عن كمية غير عادية من نيترات الأمونيوم المخزّنة هناك لأسبابٍ غامضة، من دون ضوابط كافية. إن التحقيقات القضائية اللبنانية في الجرائم ذات البُعد السياسي لها تاريخ من عدم الوصول إلى كشف الحقيقة. وبعد مرور عام، أعطت جهود «حزب الله» لترهيب المحقّقين وإيقاف عملهم في حدّ ذاتها دليلاً كافياً على أنها للتستّر على أمرٍ ما.
بالنسبة إلى الأميركيين؛ كثيراً ما يُنظر إلى لبنان على أنّه سلسلة من المشاكل المحيّرة التي تثير قلقنا، لكنّها لا تشكّل شاغلاً حيوياً لنا. لقد انجذبت أميركا إلى لبنان بشكل عرَضي فقط لأسباب أكبر من ذلك البلد. بحكم مكانته الجغرافية وتركيبته الطائفية. قدره أن يكون مسرحاً للصراعات الأوسع نطاقاً التي يمكن أن تعصف بالشرق الأوسط في أي وقت من الأوقات.
لقد حدّدتِ المصالحُ الأميركية المتصوّرة في تلك الصراعات والمشاكل الإقليمية سياسةَ الولايات المتّحدة تجاه لبنان، خلال الحلقات السّت التي تمّت دراستها هنا (في هذا الكتاب). ومع ذلك، فإن لبنان ليس مجرد مجموعة من المصالح الإقليمية؛ إنه مكانٌ يسكنه أشخاص مميّزون هم في آنٍ واحد ضحايا ومستفيدون من تلك الشؤون الإقليمية وكيفية تعامل قادتهم معها. والعديد منهم لديهم ارتباطات قوية بالقيم الأميركية التي لا علاقة لها بالشؤون الجيوستراتيجية
استلزمت مسيرتي المهنية، بوصفي دبلوماسياً أميركياً، الخدمة في بيروت ثلاث مرّات، امتدت على مدى خمسة وعشرين عاماً تقريباً. وقد قدّمت التجربة هناك العديد من الأمثولات عن السياسة الخارجية، ليس فقط في تلك الدولة المتنازع عليها، بل على المستويين الإقليمي والعالمي. لقد تبلورت فكرة هذا الكتاب في ذهني منذ أن قرأت مقالة صحافية رائعة حول العلاقات بين الولايات المتّحدة ولبنان بقلم بول سالم، نُشرت عام 1992 عندما بدأت أصبح على دراية بأوضاع لبنان (بول سالم، هنا وهناك).
ليس هذا الكتاب سيرة ذاتية. ولقد أبقيت نفسي في الغالب خارج الصّورة حتّى عندما كنت حاضراً؛ لتجنّب أي فهمٍ خاطئ لمحورية الشخص. ومع ذلك، فإنّه لا يسعه إلّا أن يعكس المواقف المكتسبة على مدى عمر من الاهتمام بالعلاقات اللبنانية - الأميركية، والرغبة ولو عديمة الجدوى في أننا – وأنا - قد قمنا بما هو أفضل. ولكن هناك أمثولة أخرى من أمثولات لبنان العديدة تتلخّص في محدودية القوّة الأميركية، خاصةً وللمفارقة، في بلدان ذات أهمية من الدرجة الثانية بالنسبة إلى الأمن القومي الأميركي.
أخبار ذات صلة
لجنة الطوارئ … استجابة فلسطينية موحّدة لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان
2026-03-05 10:47 ص 129
المستقبل" من تيار الوطن إلى حزب العائلة
2026-02-27 10:22 ص 256
خليل المتبولي : معروف سعد، حين صارت صيدا فكرةً… وصار الاستشهادُ مدينة
2026-02-25 10:18 ص 161
عكاظ بين ذكرى الحريري وواقع المظلومية.. الطائفة السنّية في مواجهة «عنق الزجاجة»
2026-02-18 10:18 ص 198
صيدا: حكاية تحرير وعنفوان (١٦ شباط ١٩٨٥)
2026-02-16 03:28 م 131
إعلانات
إعلانات متنوعة
صيدا نت على الفايسبوك
الوكالة الوطنية للاعلام
انقر على الزر أدناه لزيارة موقع وكالة الأنباء الوطنية:
زيارة الموقع الإلكترونيتابعنا

صور حين تتحول السيارة إلى بيت… والرصيف يصبح وطناً مؤقتاً
2026-03-07 10:57 م

بالفديو اثار القصف في مبنى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا
2026-03-07 12:16 م

رمضان في ساحة النجمة… فانوس البلدية بين الإشادة وعتب المتبرعين
2026-02-18 05:57 ص

تحليل المشهد الانتخابي في صيدا بعد خطاب دولة سعد الحريري
2026-02-14 09:42 م

٤٥ عاماً في مهنة الإعلام… شهادة حق من صيدا نت : لم يُهدر دمي من هؤلاء بمدينة